

جورج خباز: "كنت أحلم بأن أكون قدوة، ولم أكن أعلم أنني سأصبح عبرة"
2025-08-28

بقلم لميس شقير ( كاتبة ومنتجة )
«كنت أحلم بأن أكون قدوة، ولم أكن أعلم أنني سأصبح عبرة»… بهذه العبارة صدح الفنان والمبدع جورج خباز من على خشبة مسرح كازينو لبنان في مسرحيته "خيال صحرا" مع زميله عادل كرم، لا ليؤديا دورًا فحسب، بل ليكشفا وجعًا بلغة حقيقية بسيطة يفهمها جميع من يقطن في ال١٠٤٥٢ كم والمنتشرون منه حول العالم…هذه المسرحية كغيرها لم تكن مجرد سرد فيها الكلمات متساوية بين شرقية وغربية بل كانت استدعاء لذاكرة جماعية، حيث الألم لم يبدأ في سبعينيات القرن الماضي، لكنه تجذّر فيها، في محطة ليست الوحيدة، محطة ما زالت تطاردنا حتى اليوم.
لم تكن الحرب وليدة لحظة، في تلك المرحلة، خيّم الألم على لبنان، لا بسبب خلاف داخلي فحسب، بل نتيجة تداخل إقليمي ودولي، حيث اصطدمت الرأسمالية بالاشتراكية، واصطدم اليمين باليسار، في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة، في جسد وطن هشّ تحت شماعة الأديان والطوائف وهواجس الخوف من الآخر.
الحرب التي سُمّيت "أهلية" تجاوزت أهلها، وامتدت إلى تحالفات ومصالح، قتلت من قتلت ونُثرت في زواريب السياسات والانتماءات والاختلافات فمزّقت النسيج الوطني بشظايا كشفت عن انقسام عمودي في مفهوم الوطن، وفي تعريف الصديق والعدو، وانقسام أفقي آخر، ارتدى عباءة الدين والقوميات.
مقاتلون رضخوا لأوامر عليا، تحت شعار الدفاع عن وطن شاب، فُرضت عليه سلطات وميليشيات وسياسات متناحرة. أما الرغبات، فبقيت تتخبط في التكوين البشري لإنسان فُطر على المحبة، ولم تنتصر آنذاك سوى مشاعر الكره فخسر لبنان وأصبح القتل في مدينة الشرائع مباحا.
أولئك المسلّحون، لم يملكوا سوى سلاحٍ بات هويتهم ومصدر عيشهم، لا مجرد أداة قتال. وساعات الهدنة التي عاشها المقاتلون – المقاومون – الميليشياويون، لم تكن سوى استراحة مؤقتة بانتظار نتائج القمم والمعاهدات والاتفاقيات ليكملوا ما يملى عليهم، بعد وداع الأحباب في زوايا البيوت المهجورة. وأصبح السلاح أداة سياسية، والدم وسيلة للتفاوض، والهدنة لحظة انتظار بين جولات وصولات تُعاد فيها صياغة التحالفات، وتُستبدل فيها الشعارات، وتوالت المجازر ودخلت القوات السورية وإسرائيل، ثم حرب التحرير وحرب الإلغاء، ثم الطائف، ليعلن دمج الخط الأخضر فلم يعد فاصل جغرافيا، وبقي شقًا في الوعي الوطني. انتهت الحرب وبقيت خطوط التماس في عقولنا، وشاخ المقاتلون ونشأ جيل جديد يحمل آثارها في لاوعيه، فيما جيل آخر رحل بحثًا عن أفق جديد.
لم تكن أكياس الرمل مجرد حواجز بين الخصوم، لأنها حين جُرفت بقيت أيضا في عقول البعض وتُرجمت اليوم بأسئلة بالية من سطوع الشمس عليها، باهتة من كثرة تكرارها، وغبية في صيغة طرحها. "الاسم الكريم؟ وإن لم يجدوا فيه دلالة دينية، يأتي السؤال الآخر. وين عايش/ة؟ وإن قلت بيروت، يأتي السؤال: من أي منطقة؟" كل هذا لتحديد مسار الحديث المنمق باختيار كلمات تظهر للآخر انفتاحا مزيفا وتحمل بين سطورها خبث المشاعر.
بعد وقف إطلاق النار، لم يُطوَ السلاح، بل امتد ليصبح ثقافة متجذّرة، تُورّث وتُعاد ويصعب انتزاعها. هذا السلاح غير المرئي لم ينتزع إلى اليوم ويحتاج وقتا أطول من رفيقه الملموس رغم الفرق الشاسع في الأسباب، المضمون، والأهم السياق. فالأخير عملية معقدة جدا وتحتاج أيضا إلى الوقت ونماذج كثيرة تروي لنا هذا التحدي في دول عدة خاضت هذه التجربة الحسية الدقيقة واختلفت في نتائجها. فالسلاح، ليس لعبة تُنتزع من يد طفل صغير، بل هو أكبر من ذلك بكثير.
بالعودة إلى السبعينيات، لم تكن الحرب "الأهلية" المحطة الأولى ولا الأخيرة، ففي العقد الأخير، تراكمت محطات أخرى من انتفاضة ٢٠١٩، إلى جائحة كورونا، إلى الانهيار المالي الذي أطاح بالطبقة الوسطى وأزمة الطاقة التي أغرقت البلاد في العتمة، إلى انفجار مرفأ بيروت الذي ما زال جرحًا مفتوحًا لم تُشفِه العدالة بعد... وإلى جانب تدفق النازحين السوريين واستمرار الوجود الفلسطيني، جاءت أزمات المنطقة لتزيد المشهد تعقيدًا وغموضًا.
هذه الأزمات التي تراكمت فوق نسيج هشّ من مخلفات الحرب وما قبلها من أحداث، ما زالت تعاني الانقسامات وهذا الماضي القريب الذي رقص فوق الجثث التي اقتنصوها، ما زال يخبرنا حكايات مليئة بالتحديات التي نضيفها إلى الواقع المرّ، ولم يتبق لنا سوى الهروب منه بعلاج جماعي فنيّ بقصص رواها مبدعون وأصبحوا هم "المعالجون" يتحدّون هذا الواقع ويخلقون منها تحفا فنية، تفرغ عبئا أتعبنا، وحملا في صدورنا، تلهمنا، تحاكي مخاوفنا، ترسم حلما وربما توجد حلّا.
وهذه المحاولات الفنية العلاجية التي تنطلق من مبدأ فهم الآخر والتحدث معه بلغة بسيطة مشتركة، لغة تعيد كتب التاريخ الموحد إن استطعنا بحجة السرديات المختلفة، لغة ترمم الذاكرة وتحفظها، والوظيفة التوعية، وحتى العدالة… ليتضح لنا أن لغة الفن تحاول قدر الإمكان تغطية غياب العناصر الأساسية الأخرى في رحلة العلاج كدور الدولة في مواجهة هذا الواقع المتشظي فتحملت ما لا تقدر على حمله وحدها.
الفن الرزين في لبنان ليس ترفًا فقط، بل رسالة وأحيانا ضرورة وجودية في بلدٍ تتنازع فيه الروايات، وأرشيفًا نعيد سرده بهذه اللغة الحرّة ربما نفتح بها نافذة مشرقة نحو قدر جديد. لهذا انتفض "المعالجون"، كجورج وآخرون بأفكارهم المبدعة، المنثورة كتابة وشعرا، المقروءة خطابا وشعارا، الملحنة على وتر هادىء بلحن فيروزي يرنَّم منذ نشأة الوطن. رقصات مشتركة تنسينا النحن والآخر، ولمسات فنية ترسمها أنامل وأخرى صخرية ناطقة، تعكس الحالة والزمان.
هذا الفن يساعدنا في المصالحة والمصارحة والمسامحة وإبراز ودعم الشخصيات المفكرة المعتدلة الموزونة التي يحتاجها الوطن اليوم في شتى المجالات. لهذا لا يمكن اختزال الفن وخاصة في لبنان في دوره الجمالي الترفيهي أو العاطفي لأنه أكثر من ذلك بكثير هو وسيلة للتفكير والمساءلة، وأداة لإعادة بناء الوعي العام. لكن أثره يكبر أكثر فأكثر حين يكون ضمن دولة القانون والحريات.
فهل لنا أن نعتبر؟ أم أننا سنظل ندور في دوامة لا مخرج لها سوى دولة القانون المحايدة التي تعلو كل التحالفات والسياسات الخارجية، وحينها فقط ا لن نتفرج على مسارح مآسينا وانقساماتنا ونبكي الأطلال على مظلوميتنا، ونحن المتواطئون في أداء دور الضحيّة، المستسلمون لأفكار سامة يطرحها البعض في الغرف الضيقة.
لا توجد تعليقات بعد.
آخر الأخبار

هّمة الرجال تقلع الجبال
البروفسور جهاد نعمان

أنطولوجيا الأمومة والتكاؤن الإنساني
بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن

إعادة بناء الدولة اللبنانية
بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن
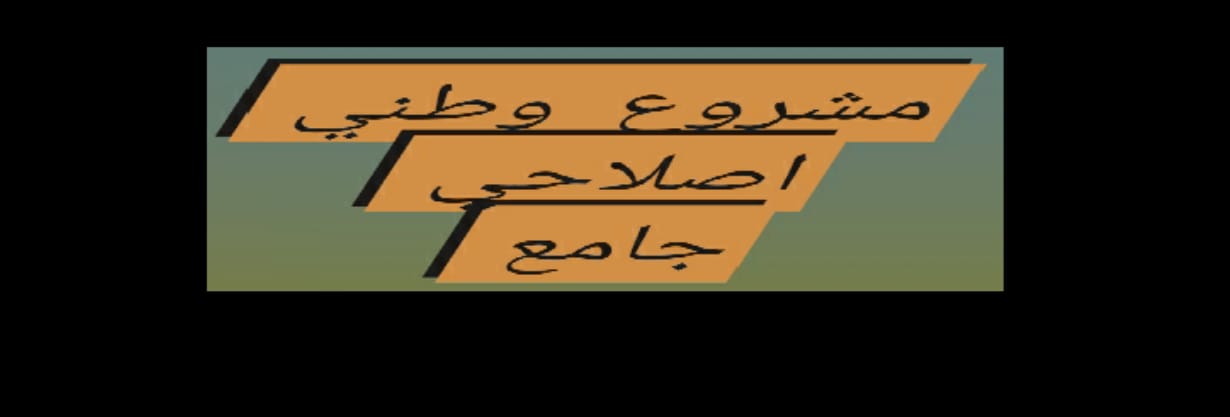
لبنان بين أسر الماضي وتحوّلات الحاضر: نحو مشروع وطني إصلاحي جامع
الدكتور هشام الأعور

حضرة أصحاب السماحة والمعالي والسعادة، السادة منظّمي لقاء «الأخوّة الإنسانية كأساس لمستقبل مشترك»،
المكتب الإعلامي لجمعية التكاؤن

الحكم في لبنان وإشكالية إعادة بناء الدولة:
بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن

بلاغة الصمت :
المكتب الإعلامي لجمعية التكاؤن

"دولة في رجل"
المكتب الإعلامي لجمعية التكاؤن

scientific “phenomena”
SAMIR ROBERT NACCACHE
Copyrights © 2025 All Rights Reserved. | Powered by OSITCOM