

بحث في أنطولوجيا العلاقة، والدين، وإنسانية الإنسان
التكاؤُن الإطار الفلسفي–الروحي لتكوُّن الوجود الإنساني والمعنى
2026-02-02

بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن
التكاؤُن
الإطار الفلسفي–الروحي لتكوُّن الوجود الإنساني والمعنى
بحث في أنطولوجيا العلاقة، والدين، وإنسانية الإنسان
المؤلف: د. فريد جبور
التاريخ: 2026
المقدّمة التأسيسية الموسَّعة
يشهد الوجود الإنساني المعاصر أزمةً مركّبة لا يمكن ردّها إلى اختلالٍ عابر في منظومة القيم، ولا إلى نقصٍ في المعرفة أو فشلٍ في النظم السياسية والاقتصادية، بل تتجلّى بوصفها أزمة بنيوية في العلاقة ذاتها؛ علاقة الإنسان بذاته، وبالآخر، وبالعالم، وبالمصدر الذي يمنح الوجود معناه. ففي الوقت الذي بلغ فيه العقل الإنساني مستويات غير مسبوقة من التقدّم العلمي والتقني، تراجعت قدرة الإنسان على إنتاج المعنى، وتفكّكت الروابط التي كانت تؤسّس إنسانيته، وتحوّل الوجود إلى سلسلة وظائف، وهويات، وأدوار، منفصلة عن شروط تكوّنها الوجودي (4)(18)(19).
لم يعد الإنسان المعاصر يعيش داخل شبكة علاقات مولِّدة للمعنى، بل داخل منظومات تشغيل وإدارة واستهلاك، تُنتج أشكالًا جديدة من الاغتراب والعنف والفراغ الوجودي. وقد أدّى هذا التحوّل إلى تفكّك البنى الاجتماعية، وتصاعد العنف الرمزي والمادي، وعودة الصراعات الدينية والهوياتية، لا بوصفها تعبيرًا عن فائض إيمان أو اختلاف ثقافي أصيل، بل بوصفها أعراضًا لانهيار أعمق في العلاقة التي تجعل الإنسان قادرًا على رؤية ذاته في الآخر، والآخر في ذاته (6)(10)(21).
إن المقاربات السائدة لمعالجة هذه الأزمة—سواء كانت أخلاقية، قانونية، سياسية، أو حتى دينية—تظلّ قاصرة، لأنها غالبًا ما تتعامل مع النتائج دون أن تمسّ البنية التي تُنتجها. فهي تُكثر من القوانين حيث تنهار الثقة، وتُكثّف الخطاب الأخلاقي حيث يغيب المعنى، وتستدعي الدين حيث تفشل العلاقة، من دون أن تعيد مساءلة الأساس الذي تقوم عليه إنسانية الإنسان نفسها (5)(13).
ينطلق هذا البحث من فرضية إطارية مركزية مفادها أن جوهر الأزمة الإنسانية المعاصرة هو انهيار العلاقة بوصفها بنية أنطولوجية، وأن أي محاولة جدّية لإعادة تأسيس إنسانية الإنسان لا يمكن أن تنجح ما لم يُعاد التفكير في الكيفية التي يتكوّن بها الإنسان أصلًا. فالسؤال الحاسم الذي يوجّه هذا البحث ليس سؤال السلوك («كيف يجب أن نتصرف؟») ولا سؤال التنظيم («كيف يجب أن نُنظّم المجتمع؟»)، بل سؤال أعمق وأكثر جذرية:
كيف يتكوّن الإنسان أصلًا؟ وعلى أي أساس تقوم إنسانيته؟ (4)(6)
ضمن هذا الأفق، يقترح البحث مفهوم التكاؤُن بوصفه الإطار الفلسفي–الروحي القادر على إعادة بناء التفكير في الوجود والمعنى والدين والمجتمع. فالتكاؤُن لا يدلّ على مجرّد تعايش أو تعاون أو تضامن أخلاقي، بل يشير إلى التكوّن المتبادل للوجود داخل العلاقة، حيث لا تُفهم الذات بوصفها جوهرًا مكتملًا يسبق العلاقة، ولا يُفهم الآخر بوصفه إضافة خارجية أو تهديدًا، بل يتشكّل كلٌّ منهما داخل علاقة مؤسسة للكينونة والمعنى في آن واحد (8)(15).
وعلى هذا الأساس، لا يعود تمنّي الخير للآخر فعلًا أخلاقيًا مثاليًا أو عبثيًا، بل نتيجة بنيوية لحقيقة أن الذات لا تقوم إلا داخل العلاقة، وأن ما يصيب الآخر يصيب في العمق البنية التي تتكوّن فيها الذات نفسها. فالإنسان لا يتقدّم نحو خالقه، ولا يكتشف معنى وجوده، إلا بقدر ما يجد ذاته في أخيه، ويعترف بأن إنسانيته مشروطة بإنسانية الآخر (6)(16)(23).
من هنا، تُعاد صياغة مفهوم إنسانية الإنسان لا بوصفه خاصية فردية ثابتة أو امتيازًا جوهريًا، بل بوصفه حدثًا علائقيًا مستمرًا، يتكوّن ويتجدّد داخل التماثل دون تطابق، والاختلاف دون إقصاء، والاعتراف المتبادل بوصفه شرط الوجود لا مجرّد قيمة مضافة. وقد بيّنت الفلسفة الحديثة والمعاصرة أن الذات التي تُغلق على نفسها تفقد قدرتها على المعنى، وتتحوّل إمّا إلى عنف أو إلى فراغ وجودي (15)(10).
في هذا السياق، يعيد البحث قراءة الدعوات والنبوات والأديان الكبرى، لا بوصفها أنظمة تشريعية مفروضة من خارج التاريخ، ولا بوصفها تجارب روحية فردية معزولة، بل بوصفها استجابات تاريخية–روحية لانهيار التكاؤُن داخل الجماعة الإنسانية. فالنبوة، في عمقها، ليست امتيازًا فرديًا، بل وظيفة وجودية تظهر حين يختلّ التوازن بين الواحد والجماعة، وحين تتحوّل العلاقة إلى ظلم أو قهر أو إقصاء (3)(11).
كما تُفهم الشريعة، والغفران، والخلاص، والتوبة، والرهبنة، والاستخلاف، بوصفها محاولات مختلفة لإعادة بناء العلاقة حين تنكسر، لا بوصفها أدوات ضبط أو هيمنة. فالدين، في أفق هذا البحث، لا يُقاس بقدر ما يفرض من قواعد، بل بقدر ما يعيد للإنسان قدرته على العيش مع الآخر من دون إلغاء، ومع الله من دون خوف، ومع العالم من دون استباحة (22)(23)(32).
يعتمد هذا البحث منهجًا تركيبيًا يجمع بين التحليل الفلسفي الأنطولوجي، والمقاربة اللاهوتية المقارنة، والتحليل الأنثروبولوجي والاجتماعي، والاستعانة بعلوم اللغة والرمز والتاريخ وعلم النفس الاجتماعي، من دون إخضاع حقلٍ لحقل، بل ضمن رؤية تكاؤنية ترى المعرفة نفسها فعلًا علائقيًا يتكوّن داخل شبكة من التفاعلات الإنسانية والتاريخية (7)(11)(17).
وينتظم البحث في ثلاثة أقسام كبرى مترابطة:
– يؤسّس القسم الأوّل للإطار الأنطولوجي للتكاؤُن عبر تحليل فلسفي مقارن ينتقل من أنطولوجيا الجوهر إلى أنطولوجيا العلاقة.
– ويعالج القسم الثاني الدين والدعوات والنبوات معالجة لاهوتية–تكاؤنية معمّقة تُبرز البعد العلائقي للخلاص والمعنى.
– فيما يخصّص القسم الثالث لتحليل إنسانية الإنسان والمصير المشترك في أفق أنثروبولوجي–تاريخي.
لا يدّعي هذا البحث تقديم أجوبة نهائية، بل يسعى إلى فتح أفق فكري يعيد طرح سؤال الإنسان والمعنى والدين على أساس العلاقة لا الهيمنة، وعلى التكاؤُن لا الانعزال، بوصفه شرطًا أنطولوجيًا وروحيًا لقيام إنسانية الإنسان في عالم يتآكل فيه المعنى (12)(20).
القسم الأوّل
التكاؤُن بوصفه بنية أنطولوجية للوجود
1. من أنطولوجيا الجوهر إلى أنطولوجيا العلاقة: نقد الأساس الميتافيزيقي التقليدي
هيمنت أنطولوجيا الجوهر على تاريخ الفلسفة الغربية منذ أرسطو، حيث جرى تعريف الكائن انطلاقًا مما هو عليه في ذاته، أي بوصفه حاملًا لماهية ثابتة تسبق كل علاقة وتبقى قائمة بمعزل عنها (1). وقد شكّل هذا التصوّر الإطار المرجعي لفهم الطبيعة والإنسان معًا، فغدا الوجود الإنساني يُفهم بوصفه وجودًا لذات مكتملة، تدخل في علاقات لاحقة بوصفها إضافات عرضية لا تمسّ جوهر الكينونة.
غير أن هذا النموذج، على الرغم من تماسكه المنطقي، أظهر محدوديته البنيوية عندما نُقل من مجال الطبيعة إلى مجال الإنسان. فالإنسان، بخلاف الموجودات الطبيعية، لا يمكن اختزاله إلى ماهية ثابتة، إذ إن وعيه، ومعناه، وهويته، ومسؤوليته، لا تتكوّن إلا داخل علاقة حيّة بالآخرين وبالعالم وبالزمن. وقد أدّى الإصرار على أنطولوجيا الجوهر في فهم الإنسان إلى نتائج إشكالية، أبرزها تحويل الآخر إلى موضوع، والعلاقة إلى أداة، والمعنى إلى ملكية فردية (6)(15).
في هذا السياق، يمثّل التحوّل الذي أدخله مارتن هايدغر في الوجود والزمان لحظة مفصلية، إذ أعاد تعريف الوجود الإنساني بوصفه وجودًا-في-العالم، لا ذاتًا تقف في مواجهة عالم خارجي (4). فالإنسان، عند هايدغر، لا يوجد أولًا ثم يدخل العالم، بل يوجد دائمًا منفتحًا على شبكة من العلاقات العملية والدلالية. غير أن هذا التحليل، على أهميته، ظلّ عند مستوى توصيف بنية الوجود الإنساني، من دون أن يجعل العلاقة نفسها المبدأ التأسيسي للكينونة.
ينطلق هذا البحث خطوة أبعد، ليقترح أن العلاقة ليست نمطًا من أنماط الوجود، بل شرط الوجود ذاته. فالذات لا تسبق العلاقة، والآخر لا يأتي لاحقًا، بل ينبثقان معًا داخل فعل تكوُّن متبادل. ومن هنا، لا يمكن فهم الإنسان بوصفه جوهرًا يدخل في علاقة، بل بوصفه كينونة تتكوّن عبر العلاقة.
يتقاطع هذا الطرح مع فلسفة الحوار عند مارتن بوبر، الذي ميّز بين علاقة “أنا–هو” وعلاقة “أنا–أنت”، مبيّنًا أن الوجود الإنساني الأصيل لا يتحقّق إلا في أفق العلاقة الثانية، حيث لا يُختزل الآخر إلى موضوع معرفة أو استعمال (8). غير أن البحث الحالي يتجاوز البعد الأخلاقي–الحواري عند بوبر، ليؤكّد أن العلاقة “أنا–أنت” ليست فقط أفقًا وجوديًا أسمى، بل المستوى الذي تتكوّن فيه الذات ذاتها.
كما يلتقي هذا التحليل مع نقد إيمانويل ليفيناس للميتافيزيقا الغربية، التي جعلت الكلّية مبدأ الفهم، وأقصت الآخر بوصفه لانهائيًا لا يُختزل (6). فالآخر، في منظور ليفيناس، ليس موضوع معرفة، بل شرط أخلاقي سابق لكل تفكير. غير أن هذا البحث يضيف بعدًا أنطولوجيًا إلى هذا الطرح، معتبرًا أن الآخر ليس فقط شرط الأخلاق، بل شرط الكينونة الإنسانية نفسها.
من هنا، تصبح أنطولوجيا الجوهر عاجزة عن تفسير نشأة المعنى، لأن المعنى لا يُنتج داخل ذات مغلقة، بل ينكشف داخل علاقة حيّة. وقد بيّن بول ريكور أن الهوية الإنسانية لا تُفهم إلا بوصفها هوية سردية، تتكوّن عبر الاعتراف المتبادل والذاكرة المشتركة (11). فالذات التي لا تجد من يعترف بها تفقد إمكانية سرد ذاتها، وبالتالي تفقد معنى وجودها.
وعلى هذا الأساس، لا يكون الانتقال من أنطولوجيا الجوهر إلى أنطولوجيا العلاقة مجرّد تعديل نظري، بل تحوّل جذري في فهم الإنسان والعالم والمعنى. فالوجود الإنساني لا يقوم على الامتلاك، بل على الانكشاف؛ لا على السيطرة، بل على المشاركة؛ لا على الانعزال، بل على التكاؤُن.
ويمهّد هذا التحليل للانتقال إلى العنوان الفرعي الثاني، الذي سيعالج مفهوم التكاؤُن ذاته بوصفه مبدأ أنطولوجيًا للتكوُّن المتبادل، مع تفكيك دلالاته الفلسفية والتمييز بينه وبين مفاهيم قريبة مثل التفاعل، والتضامن، والتعايش
2. التكاؤُن: تعريف المفهوم وتمييزه عن مفاهيم العلاقة التقليدية
يُستعمل مفهوم العلاقة في الخطاب الفلسفي والاجتماعي استعمالًا واسعًا، غالبًا من دون تدقيق في مستواه الأنطولوجي. فالعلاقة تُفهم، في معظم المقاربات الكلاسيكية، بوصفها رابطة تقوم بين كيانين مكتملين سلفًا، بحيث تكون العلاقة لاحقة على الوجود، لا شرطًا له. وبهذا المعنى، تُختزل العلاقة إلى تفاعل، أو تبادل، أو تضامن، أو تعايش، وهي جميعها مفاهيم تفترض وجود ذوات مستقلة تدخل في علاقات من دون أن تمسّ هذه العلاقات بنيتها الوجودية (5)(7).
ينطلق مفهوم التكاؤُن، كما يُعتمد في هذا البحث، من نقد هذا الافتراض الضمني. فالتكاؤُن لا يشير إلى علاقة بين كيانين جاهزين، بل إلى عملية تكوُّن متبادل تجعل الكيانين ممكنين أصلًا. وبذلك، لا تكون العلاقة إضافة عرضية على الجوهر، بل تكون البنية التي يتشكّل فيها الجوهر ذاته. إنّ ما يُعاد التفكير فيه هنا ليس كيفية ارتباط الذوات بعضها ببعض، بل كيفية نشوء الذات والآخر داخل فعل علائقي سابق على كل تحديد.
ومن هنا، يختلف التكاؤُن جذريًا عن مفهوم التفاعل الذي يفترض أطرافًا مستقلّة تتبادل التأثير، من دون أن يتغيّر أساس هويتها. فالتفاعل، مهما بلغ من الكثافة، يبقى خارجيًا إذا لم يمسّ شروط تكوُّن الذات. أما التكاؤُن، فيفترض أن كل طرف يتكوّن بقدر ما يكوِّن الآخر، وأن الانفصال الكامل ليس حالة أصلية بل تجريد نظري (8)(15).
كما يختلف التكاؤُن عن مفهوم التضامن، الذي ينتمي أساسًا إلى الحقل الأخلاقي–السياسي، ويُعنى بتنسيق الأفعال أو المصالح داخل جماعة قائمة. فالتضامن يفترض مسبقًا ذوات مكتملة تتعاون أو تتكاتف، في حين أن التكاؤُن يشتغل في مستوى أعمق، حيث تتكوّن الذوات نفسها داخل بنية علائقية سابقة على أي تنسيق أخلاقي أو قانوني (5)(10).
ويتميّز التكاؤُن كذلك عن مفهوم التعايش، الذي غالبًا ما يُستعمل للدلالة على إدارة الاختلاف أو تقليل الصراع بين جماعات متجاورة. فالتعايش، في صيغته الشائعة، لا يقتضي اعترافًا متبادلًا عميقًا، بل يكفي فيه الامتناع عن العنف. أمّا التكاؤُن، فيفترض أن الاختلاف نفسه لا يُحتمل إلا إذا كان جزءًا من بنية تكوُّن مشتركة تجعل الآخر شرطًا للذات، لا عبئًا عليها (6)(16).
من الناحية الأنطولوجية، يمكن تعريف التكاؤُن بوصفه نمط وجود تتكوّن فيه الكينونة عبر الانفتاح المتبادل، بحيث لا تُفهم الهوية إلا بوصفها هوية علائقية، ولا يُفهم المعنى إلا بوصفه انكشافًا يحدث داخل العلاقة. وقد بيّن بول ريكور أن الهوية الإنسانية لا تُختزل إلى تطابق مع الذات، بل تتشكّل عبر سرد يتضمّن الآخر والزمان والذاكرة المشتركة (11). وفي أفق التكاؤُن، يصبح هذا السرد فعلًا علائقيًا بامتياز.
يقتضي هذا الفهم إعادة النظر في الثنائية التقليدية بين الواحد والمتعدد. فالتكاؤُن لا يُلغي الواحد في المتعدد، ولا يذيب المتعدد في الواحد، بل يقيم وحدة علائقية تحفظ التمايز داخل التكوُّن المشترك. وهنا يلتقي هذا التصوّر مع بعض التيارات الفلسفية غير الغربية، ولا سيما مبدأ الاعتماد المتبادل في البوذية، الذي ينفي وجود الجوهر المستقل ويؤكّد ترابط الكائنات في نشأتها وبقائها (36).
غير أن التكاؤُن، كما يُطرح في هذا البحث، لا يقتصر على توصيف الترابط، بل يؤسّس لمسؤولية وجودية. فإذا كانت الذات لا تتكوّن إلا في العلاقة، فإن كل فعل يُلحق ضررًا بالآخر يُصيب في العمق شروط تكوُّن الذات نفسها. ومن هنا، لا يكون البعد الأخلاقي إضافة لاحقة، بل نتيجة مباشرة لبنية أنطولوجية علائقية (6)(10).
وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن التكاؤُن يشكّل إطارًا أنطولوجيًا جامعًا يسمح بإعادة تنظيم المفاهيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية على أساس جديد. فبدل أن تُبنى الأخلاق على أوامر خارجية، أو تُبنى السياسة على توازن قوى، أو يُفهم الدين بوصفه منظومة تشريعية، يصبح الجميع مشتقًّا من سؤال واحد: كيف نحفظ شروط التكوُّن المتبادل للوجود الإنساني؟
ويمهّد هذا التحليل للعنوان الفرعي الثالث، الذي سينتقل من التعريف المفهومي إلى معالجة الذات والآخر بوصفهما نتاجين للتكاؤُن، لا طرفين سابقين عليه، مع تحليل مسألة الاعتراف والمسؤولية والتماثل والاختلاف.
3. الذات والآخر: التكوُّن المتبادل والاعتراف بوصفه شرط الوجود
شكّل مفهوم الذات محورًا مركزيًا في الفلسفة الحديثة، حيث جرى تعريف الإنسان بوصفه ذاتًا واعية بذاتها، قادرة على التفكير والاختيار والتصرّف انطلاقًا من مركز داخلي مستقل. وقد بلغ هذا التصوّر ذروته مع ديكارت، الذي جعل الوعي بالذات أساس اليقين والوجود معًا (2). غير أن هذا التأسيس، على الرغم من قوّته المنهجية، أرسى نموذجًا للذات المنعزلة، التي تُفهم بوصفها مكتفية بذاتها، وتدخل في علاقة مع الآخر من موقع السيطرة أو المعرفة أو الاستخدام.
أدّى هذا التصوّر إلى اختزال الآخر في كونه موضوعًا للتمثيل أو التملّك، بحيث تُقاس العلاقة بمدى قدرة الذات على استيعاب الآخر داخل منظومتها المفهومية. وقد نبّه إيمانويل ليفيناس إلى خطورة هذا المنحى، معتبرًا أن الفلسفة الغربية قامت، في جوهرها، على إخضاع الآخر للكلّية، ونزع لانهائيته، وتحويله إلى عنصر داخل نظام الذات (6). فالآخر، في هذا الأفق، لا يُستقبل بوصفه شرطًا للذات، بل بوصفه عائقًا أو خطرًا أو موضوعًا.
ينطلق مفهوم التكاؤُن من قلب هذا النقد، ليقلب المعادلة رأسًا على عقب. فالذات، في أفق التكاؤُن، لا تُفهم بوصفها أصل العلاقة، بل بوصفها نتاجًا لها. فالإنسان لا يولد ذاتًا مكتملة ثم يلتقي بالآخر، بل يتكوّن بوصفه ذاتًا من خلال هذا اللقاء. ومن هنا، لا يكون الآخر إضافة خارجية إلى الوجود الذاتي، بل شرط ظهوره أصلًا.
يتقاطع هذا الفهم مع فلسفة الحوار عند مارتن بوبر، الذي رأى أن علاقة “أنا–أنت” هي اللحظة التي يتحقّق فيها الوجود الإنساني الأصيل، في مقابل علاقة “أنا–هو” التي تختزل الآخر إلى موضوع (8). غير أن التكاؤُن يذهب أبعد من ذلك، إذ لا يكتفي بجعل “أنا–أنت” أفقًا أخلاقيًا أو وجوديًا مفضّلًا، بل يجعلها الشرط التكويني للذات نفسها. فالذات لا توجد أولًا ثم تختار الدخول في علاقة “أنا–أنت”، بل تتكوّن بوصفها ذاتًا فقط داخل هذه العلاقة.
من هنا، يكتسب مفهوم الاعتراف بعدًا أنطولوجيًا، لا مجرّد بعد أخلاقي أو اجتماعي. فقد أظهر هيغل أن الوعي بالذات لا يكتمل إلا عبر الاعتراف المتبادل، وأن الذات التي لا تُعترف بها تبقى ناقصة الوجود (15). غير أن جدلية الاعتراف الهيغلية بقيت، في كثير من قراءاتها، أسيرة منطق الصراع، حيث يُنتزع الاعتراف بالقوة، ويُنتج علاقات سيطرة تنتهي بتشييء الطرفين.
يقدّم التكاؤُن بديلًا عن هذا المنطق الصراعي، إذ يجعل الاعتراف نتيجة طبيعية للتكوُّن المشترك، لا ثمرة مواجهة. فالذات التي تدرك أنها لا تتكوّن إلا في الآخر لا تحتاج إلى انتزاع الاعتراف، بل تتلقّاه بوصفه شرط وجودها، كما تمنحه للآخر في الوقت نفسه. وهنا، يتحوّل الاعتراف من آلية صراع إلى بنية وجودية تحفظ التمايز داخل الوحدة.
يتجلّى هذا البعد بوضوح في التحليل السردي للهوية عند بول ريكور، الذي بيّن أن الإنسان لا يستطيع أن يحكي ذاته إلا داخل شبكة من العلاقات والذاكرات المشتركة (11). فالهوية ليست تطابقًا مع الذات، بل مسارًا سرديًا يتضمّن الآخر، والزمن، والاختلاف. وفي أفق التكاؤُن، يصبح هذا السرد فعلًا تكوينيًا، لا مجرّد تمثيل لغوي.
كما تؤكّد علوم النفس التنموي أن الوعي بالذات لا ينشأ في عزلة، بل يتكوّن عبر التفاعل المبكر مع الآخر، ولا سيما في علاقة الطفل بمحيطه الأول (14). فالذات، منذ نشأتها، هي ذات علائقية، وما يُسمّى بالاستقلال ليس إلا مرحلة متقدّمة من التكوُّن العلائقي، لا نفيًا له.
وعلى هذا الأساس، لا يعود الآخر تهديدًا لهوية الذات، بل شرط تحققها. فالاختلاف لا يُفهم بوصفه خطرًا، بل بوصفه المجال الذي تتشكّل فيه الهوية من دون أن تنغلق على ذاتها. ومن هنا، فإن كل مشروع فكري أو سياسي أو ديني يُقصي الآخر، أو يختزله إلى هوية مغلقة، يُنتج في العمق إنسانًا ناقص التكوُّن، حتى لو ادّعى حماية الذات أو الجماعة.
يبيّن هذا التحليل أن الذات والآخر ليسا طرفين متقابلين، بل قطبين لعملية تكوُّن واحدة. وحين تنهار هذه العملية، إمّا عبر العنف أو الإقصاء أو الإنكار، ينهار معها المعنى، وتتحوّل الذات إلى كيان دفاعي أو عدواني، فاقد للقدرة على الاعتراف أو الغفران.
ويمهّد هذا الفهم للعنوان الفرعي الرابع والأخير من القسم الأوّل، الذي سيتناول التماثل والاختلاف والمعنى بوصفها نتائج مباشرة لبنية التكاؤُن، مع تحليل أثر ذلك في الأخلاق والدين والمجتمع.
القسم الثاني
التكاؤُن والدعوات والنبوات والدين
من انكسار العلاقة إلى إعادة بنائها
تمهيد القسم الثاني
ينتقل هذا القسم من التأسيس الأنطولوجي للتكاؤُن إلى اختباره في المجال الذي بلغ فيه سؤال العلاقة أقصى كثافته التاريخية والروحية: مجال الدين والدعوات والنبوات. فالدين، في أفق هذا البحث، لا يُفهم بوصفه إضافة فوق-إنسانية تُفرض على واقع إنساني مكتمل، ولا بوصفه منظومة تشريعية تُقنّن السلوك من الخارج، بل بوصفه استجابة وجودية لانهيار التكاؤُن داخل الجماعة الإنسانية.
تاريخيًا، لا تظهر الدعوات والنبوات في لحظات الاستقرار، بل في لحظات الانكسار: حين تتحوّل العلاقة إلى هيمنة، والعدل إلى عنف مشرعن، والاختلاف إلى إقصاء، والمعنى إلى أداة سلطة. في تلك اللحظات، يتصدّع النسيج العلائقي الذي يجعل العيش المشترك ممكنًا، ويغدو الإنسان غريبًا عن أخيه، وعن ذاته، وعن العالم. من هنا، لا يكون الدين قطيعة مع التاريخ، بل محاولة لإنقاذ التاريخ من انهيار المعنى (21)(3).
ينطلق هذا القسم من فرضية مفادها أن جوهر الرسالات الدينية لا يكمن في مضمونها التشريعي فحسب، بل في وظيفتها العلائقية: إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والله، وبين الإنسان والعالم. وعلى هذا الأساس، تُعاد قراءة مفاهيم النبوة، والشريعة، والخطيئة، والخلاص، والغفران، والرهبنة، لا بوصفها مقولات منفصلة، بل بوصفها أشكالًا مختلفة لفعل واحد: ترميم التكاؤُن حين ينكسر.
سيُعالج هذا القسم أربعة محاور مترابطة:
النبوة بوصفها وظيفة تكاؤنية تاريخية،
الشريعة بوصفها حفظًا لبنية العلاقة،
الخطيئة والخلاص قراءةً علائقية،
الغفران والرهبنة كأفق لإعادة تأسيس المعنى.
1. النبوة: من الاصطفاء الفردي إلى الوظيفة التكاؤنية التاريخية
تُساء قراءة النبوة حين تُفهم بوصفها امتيازًا فرديًا أو اصطفاءً ميتافيزيقيًا يضع النبي فوق جماعته أو خارجها. فهذا الفهم، الذي تسلّل إلى قراءات لاهوتية وشعبية عديدة، حوّل النبوة إلى مصدر سلطة رمزية، وأفرغها من بعدها الوجودي العميق. أمّا في أفق التكاؤُن، فتُفهم النبوة بوصفها وظيفة تاريخية تظهر حين يختلّ التوازن العلائقي داخل الجماعة الإنسانية.
تاريخ الأديان يُظهر بوضوح أن النبي لا يظهر في مجتمع متصالح مع ذاته، بل في مجتمع تمزّقه علاقات الظلم، والهيمنة، وكسر العهد، وتحويل الإنسان إلى وسيلة. وقد بيّن غيرهارد فون راد أن الخطاب النبوي في العهد القديم لا ينطلق من فراغ، بل من انهيار العهد بوصفه علاقة حيّة بين الله والجماعة (3). فالنبوة ليست إضافة معرفية، بل كشف للخلل العلائقي باسم معنى يتجاوز اللحظة التاريخية.
في هذا السياق، لا يكون النبي حامل “معلومات” عن الله، بل شاهدًا على انكسار العلاقة، وداعيًا إلى إعادة بنائها. وقد أظهر بول ريكور أن الخطاب النبوي لا يعمل بمنطق الوصف، بل بمنطق الاستدعاء الوجودي، أي استدعاء الإنسان إلى مسؤوليته تجاه الآخر والتاريخ (11). فالنبوة ليست خطاب طمأنة، بل خطاب قلق خلّاق يزعزع البنى التي تحوّلت إلى أصنام.
يتقاطع هذا الفهم مع قراءة إيمانويل ليفيناس للخطاب الديني، حيث لا يُفهم النداء الإلهي إلا عبر وجه الآخر، الذي يفرض مسؤولية لا يمكن التهرّب منها (6). فالله، في هذا الأفق، لا يُقابل الإنسان مباشرة بوصفه موضوع معرفة، بل يحضر عبر انكسار العلاقة مع الآخر. ومن هنا، تصبح النبوة فعل كشف أخلاقي–أنطولوجي، لا امتيازًا فرديًا.
وفي الإسلام، يظهر هذا البعد بوضوح في توصيف النبي بوصفه “بشيرًا ونذيرًا”، أي من يعيد فتح أفق العلاقة حين تُغلق، لا من يفرض نظامًا قسريًا. فالقرآن لا يخاطب الإنسان بوصفه فردًا معزولًا، بل بوصفه كائنًا مسؤولًا داخل جماعة، ومستخلفًا في الأرض، أي داخل علاقة ثلاثية: الله–الإنسان–العالم (32)(35).
وعليه، لا يمكن فصل النبوة عن سياقها الاجتماعي–التاريخي، ولا عن وظيفتها التكاؤنية. فحين تُفصل النبوة عن هذا الأفق، تتحوّل إمّا إلى أسطورة، أو إلى سلطة، أو إلى خطاب وعظي فاقد للقدرة على التغيير. أمّا حين تُستعاد بوصفها وظيفة لإعادة بناء العلاقة، فإنها تستعيد قدرتها التحريرية والمعنوية.
كما يُظهر هذا التحليل أن رفض النبوة أو تديينها العنيف يشتركان في خطأ واحد: كلاهما يفصل الرسالة عن وظيفتها العلائقية. فالأوّل ينكر الحاجة إلى ترميم العلاقة، والثاني يحتكرها ويحوّلها إلى أداة إقصاء. أمّا أفق التكاؤُن، فيفتح قراءة ثالثة ترى في النبوة فعلًا تاريخيًا لإعادة إنسانية الإنسان.
يمهّد هذا الفهم للعنوان الفرعي الثاني، الذي سينتقل من وظيفة النبوة إلى مفهوم الشريعة، لا بوصفها قانونًا مفروضًا، بل بوصفها آلية لحفظ بنية العلاقة ومنع انهيارها.
2. الشريعة: من منطق القانون إلى حفظ بنية التكاؤُن
غالبًا ما تُقرأ الشريعة في الوعي المعاصر—سواء في الخطاب النقدي أو في الخطاب الديني الدفاعي—بوصفها منظومة قوانين تُفرض على الإنسان من خارج تجربته الوجودية، فتُختزل إمّا في جهاز ضبط سلوكي أو في رمز للسلطة الدينية. غير أن هذا الفهم يُسقِط الشريعة في منطق قانوني صِرف، ويُغفل وظيفتها الأعمق بوصفها آلية تاريخية–روحية لحفظ بنية العلاقة حين تكون مهدّدة بالانهيار (21)(22).
ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن الشريعة لا تظهر حيث تكون العلاقة سليمة، بل حيث تتصدّع. فهي ليست بديلاً عن الضمير، ولا نقيضًا للحرية، بل استجابة تنظيمية لانكسار التكاؤُن داخل الجماعة. فحين تفقد العلاقة قدرتها على تنظيم ذاتها عبر الاعتراف المتبادل، تتدخّل الشريعة بوصفها «ذاكرة علائقية» تُعيد تذكير الجماعة بشروط بقائها الإنساني.
في التقليد اليهودي، تُفهم التوراة بوصفها شريعة العهد، أي بوصفها إطارًا ينظّم العلاقة بين الله والشعب، لا مجرد مجموعة أوامر ونواهٍ. وقد أظهر غيرهارد فون راد أن مفهوم العهد (berith) يشكّل البنية المركزية للاهوت التوراتي، حيث لا تُفهم الوصايا إلا في سياق علاقة سبقت التشريع وتؤسّسه (3). فالوصية لا تُعطى في فراغ، بل داخل علاقة مهدّدة بالنقض، فتأتي لحمايتها لا لاستبدالها.
يتقاطع هذا المعنى مع التحليل الأنثروبولوجي لإميل دوركهايم، الذي رأى أن القواعد الأخلاقية والقانونية تنشأ من الحاجة إلى حفظ التضامن الاجتماعي، لا من إرادة قسرية معزولة (5). فالقانون، في أصله، ليس أداة قمع، بل محاولة لتثبيت شكل من أشكال العيش المشترك حين تضعف الروابط العضوية التي كانت تقوم تلقائيًا.
في المسيحية، يُعاد تأويل الشريعة جذريًا عبر مفهوم «اكتمال الناموس بالمحبة». لا يعني هذا الإلغاء، بل العودة إلى جوهر العلاقة التي وُجد الناموس لحمايتها. فحين تتحوّل الشريعة إلى غاية في ذاتها، تفقد وظيفتها التكاؤنية وتتحوّل إلى عبء يُقصي الإنسان بدل أن يحفظه. وقد بيّن بولس الرسول أن الحرف يقتل حين ينفصل عن الروح، أي حين تنقطع الشريعة عن علاقتها الحيّة بالإنسان (23).
أما في الإسلام، فتظهر الشريعة في إطار مقاصدي واضح، حيث لا تُفهم الأحكام بمعزل عن مقاصدها في حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. وقد شدّد الشاطبي على أن الشريعة وُضعت «لتحقيق مصالح العباد»، لا لإثقالهم، وأن تعطيل المقاصد يفرغ النص من روحه (35). وفي أفق التكاؤُن، تُقرأ هذه المقاصد بوصفها حماية لشروط التكوُّن الإنساني المشترك.
غير أن الخطر يكمن حين تنفصل الشريعة عن وظيفتها العلائقية، وتتحوّل إلى نظام مغلق يُقاس بمدى الانضباط الشكلي، لا بمدى حفظ العلاقة. في هذه الحالة، تتحوّل الشريعة من أداة حماية إلى أداة قهر، ومن ذاكرة جماعية إلى سلطة إقصائية. وقد أظهر ميشال فوكو كيف يمكن للأنظمة القانونية–الخطابية أن تتحوّل إلى أدوات إنتاج للهيمنة حين تنفصل عن التجربة الإنسانية الحيّة (19).
يُتيح مفهوم التكاؤُن إعادة ترتيب العلاقة بين الشريعة والحرية. فالحرية لا تُفهم هنا بوصفها تحرّرًا من كل قيد، بل بوصفها قدرة على العيش داخل علاقة عادلة. ومن ثمّ، لا تكون الشريعة نقيضًا للحرية، بل إطارًا انتقاليًا يحميها حين تكون مهدّدة بالتحوّل إلى فوضى أو عنف. فالحرية التي تُدمّر العلاقة تُدمّر ذاتها في النهاية (6)(10).
كما يسمح هذا الإطار بفهم تاريخ الصراعات الدينية على نحو أعمق. فغالبًا ما تنشب هذه الصراعات لا بسبب فائض التديّن، بل بسبب فشل الشريعة في أداء وظيفتها التكاؤنية، إمّا عبر تحجّرها وتحويلها إلى هوية مغلقة، أو عبر تفريغها من معناها وتحويلها إلى أداة سياسية. وفي الحالتين، يُصاب النسيج العلائقي في الصميم.
من هنا، يمكن القول إن السؤال الحقيقي ليس: «هل نحتاج إلى الشريعة أم لا؟»، بل: كيف نعيد وصل الشريعة بوظيفتها الأصلية في حفظ التكاؤُن؟. وهذا يقتضي قراءة تاريخية–نقدية للنصوص، لا لإلغائها، بل لاستعادة بعدها الإنساني العميق، حيث يكون القانون في خدمة العلاقة، لا العكس.
يمهّد هذا التحليل للعنوان الفرعي الثالث، الذي سينتقل إلى معالجة مفهومي الخطيئة والخلاص قراءةً تكاؤنية، بوصفهما تعبيرين عن انكسار العلاقة وإمكان ترميمها، لا بوصفهما حالتين قانونيتين منفصلتين عن التجربة الإنسانية.
3. الخطيئة والخلاص: قراءة علائقيّة في الانكسار وإمكان الترميم
تُعدّ مفاهيم الخطيئة والخلاص من أكثر المفاهيم الدينية تعرّضًا للاختزال القانوني والأخلاقي، حيث جرى التعامل معها، في كثير من القراءات التقليدية، بوصفها حالتين متقابلتين: حالة إدانة وحالة تبرئة، أو حالة سقوط وحالة نجاة فردية. غير أن هذا الفهم، على الرغم من انتشاره، يُفرغ المفهومين من عمقهما الوجودي، ويحوّلهما إلى آليتين حسابيتين تُدار بهما العلاقة بين الإنسان والله، بمعزل عن العلاقة بين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والعالم (21)(23).
ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن الخطيئة، في جوهرها، ليست مجرّد مخالفة لأمر إلهي، بل حدث علائقي يتمثّل في انكسار التكاؤُن. فهي لا تُصيب الإنسان بوصفه فردًا معزولًا، بل تُصيب شبكة العلاقات التي يتكوّن فيها وجوده ومعناه. ومن هنا، لا يمكن فهم الخطيئة إلا بوصفها خللًا في العلاقة: إمّا علاقة الإنسان بالله، أو بالآخر، أو بالعالم، وغالبًا في هذه المستويات الثلاثة معًا (6)(16).
تؤكّد القراءة الكتابية العميقة هذا المعنى. ففي سفر التكوين، لا تُقدَّم الخطيئة الأولى بوصفها مجرّد عصيان لأمر، بل بوصفها لحظة انهيار للعلاقة: انهيار الثقة بين الإنسان والله، وتحوّل الآخر إلى تهديد، والعالم إلى مجال للكدح والعناء. وقد بيّن بول ريكور، في تحليله لرمزية الشر، أن الخطيئة تُعبَّر عنها رمزيًا بوصفها انفصالًا، أو سقوطًا، أو اغترابًا، لا بوصفها مجرّد ذنب قانوني (11).
وفي اللاهوت المسيحي، يظهر هذا البعد بوضوح في فهم الخلاص بوصفه إعادة وصل ما انقطع. فالخلاص لا يُختزل في تبرئة حسابية، بل يُفهم بوصفه شفاءً للعلاقة. وقد شدّد آباء الكنيسة، ولا سيما إيريناوس، على أن ما لم يتّحد بالمسيح لم يُشفَ، أي أن الخلاص هو فعل اتحاد وترميم، لا فعل عفو مجرّد (23).
يتقاطع هذا الفهم مع قراءة إيمانويل ليفيناس، الذي رأى أن الشرّ الحقيقي لا يكمن في انتهاك قاعدة، بل في تحويل الآخر إلى شيء، أي في نفي وجهه ومسؤوليتي تجاهه (6). فالخطيئة، بهذا المعنى، ليست فقط شأنًا دينيًا، بل حدثًا أنطولوجيًا يُصيب بنية الوجود الإنساني حين يُكسر شرط التكاؤُن.
في الإسلام، يظهر هذا البعد العلائقي في توصيف الخطيئة بوصفها ظلمًا، والظلم في جوهره وضع الشيء في غير موضعه، أي كسر التوازن الذي يقوم عليه الوجود. فالقرآن لا يُركّز على الخطيئة بوصفها حالة يأس، بل يفتح دائمًا أفق التوبة، أي إمكان العودة إلى العلاقة. والتوبة، في هذا السياق، ليست اعترافًا لفظيًا، بل تحوّلًا وجوديًا يُعيد الإنسان إلى مسار التكاؤُن مع الله والناس والعالم (32)(35).
من هنا، لا يمكن فصل الخلاص عن الزمن. فالخلاص ليس حدثًا لحظيًا يُنهي الأزمة، بل مسار ترميم طويل يتطلّب إعادة بناء الثقة، والاعتراف، والذاكرة، والعدالة. وقد أظهرت الدراسات النفسية والاجتماعية أن المجتمعات التي تتجاهل البعد العلائقي للذنب والخلاص تُعيد إنتاج العنف بدل معالجته، لأن الجراح التي لم تُعالج علائقيًا تتحوّل إلى أنماط سلوكية مدمّرة (14)(18).
يسمح مفهوم التكاؤُن بإعادة ترتيب العلاقة بين الخلاص الفردي والخلاص الجماعي. فالخلاص الفردي الذي يتجاهل الجماعة يتحوّل إلى هروب روحي، والخلاص الجماعي الذي يسحق الفرد يتحوّل إلى أيديولوجيا قسرية. أمّا الخلاص في أفق التكاؤُن، فيقوم على تلازم الفرد والجماعة داخل مسار واحد، حيث يُشفى الفرد بقدر ما تُشفى العلاقة، وتُشفى العلاقة بقدر ما يتحمّل الأفراد مسؤوليتهم فيها.
كما يفتح هذا الإطار إمكان قراءة جديدة لمفهوم الفداء، لا بوصفه نقلًا آليًا للذنب، بل بوصفه فعل تضامن وجودي يتحمّل فيه البريء ثقل انكسار العلاقة ليكشف إمكان ترميمها. وقد أشار رينيه جيرار إلى أن العنف المقدّس ينشأ حين يُلقى الذنب على كبش فداء، بينما يكشف الفداء الحقيقي زيف هذا المنطق ويعيد توجيه العنف نحو المصالحة (24).
وعليه، فإن الخلاص، في أفق التكاؤُن، لا يُقاس بمدى الامتثال الشكلي، بل بمدى استعادة القدرة على العيش مع الآخر من دون خوف أو إقصاء. فحيث تُرمَّم العلاقة، يُستعاد المعنى، وحيث يُستعاد المعنى، يُفتح أفق الرجاء. أمّا حيث يُختزل الخلاص في خطاب وعظي أو قانوني، فيبقى الانكسار قائمًا، ولو تغيّرت اللغة.
يمهّد هذا التحليل للعنوان الفرعي الرابع والأخير من القسم الثاني، الذي سيتناول الغفران والرهبنة بوصفهما ممارستين وجوديتين لإعادة تأسيس المعنى، لا بوصفهما انسحابًا من العالم، بل فعلًا تكاؤنيًا داخل التاريخ.
4. الغفران والرهبنة: الانقطاع والتواصل في آن، وإعادة تأسيس المعنى
يُساء فهم الغفران والرهبنة حين يُتعامل معهما بوصفهما ممارستين فرديتين، أخلاقيتين أو زهدويتين، منفصلتين عن البنية التاريخية–الاجتماعية للوجود الإنساني. ففي هذا الفهم الاختزالي، يُختزل الغفران إلى فعل نفسي داخلي يهدف إلى راحة الذات، وتُختزل الرهبنة إلى انسحاب من العالم أو هروب من تعقيداته. غير أن هذا التصوّر يُفرغ المفهومين من قوّتهما الوجودية، ويُغفل وظيفتهما التكاؤنية العميقة بوصفهما آليتين لإعادة تأسيس المعنى حين تنكسر العلاقة (6)(23).
ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن الغفران ليس نقيض العدالة، ولا تعليقًا لها، بل فعل علائقي يهدف إلى كسر دائرة العنف الناتجة عن انكسار التكاؤُن. فالعدالة التي لا تُستكمل بالغفران تُخاطر بالتحوّل إلى إعادة إنتاج للجرح، في حين أن الغفران الذي يتجاهل العدالة يتحوّل إلى إنكار للألم. ومن هنا، لا يقوم الغفران في أفق التكاؤُن إلا بوصفه فعلًا مزدوجًا: اعترافًا بالجرح، وفتحًا لإمكان علاقة جديدة (10)(24).
وقد بيّن بول ريكور أن الغفران الحقيقي لا يُلغِي الذاكرة، بل يُعيد تأويلها، بحيث لا تبقى الذاكرة أسيرة الجرح، ولا يتحوّل الجرح إلى هوية (11). فالغفران ليس نسيانًا، بل تحريرًا للذاكرة من سلطتها التدميرية، بما يسمح للذات وللجماعة بإعادة الدخول في علاقة من دون إنكار الماضي.
يتقاطع هذا الفهم مع اللاهوت المسيحي، حيث يُقدَّم الغفران بوصفه قلب الرسالة، لا كتنازل أخلاقي، بل كقوة قادرة على كسر منطق الانتقام. فالمسيح، في قراءة تكاؤنية، لا يقدّم الغفران بوصفه مثالية أخلاقية، بل بوصفه شرطًا لاستعادة إنسانية الإنسان. وقد أشار دييتريش بونهوفر إلى أن الغفران ليس نعمة رخيصة، بل نعمة مكلِفة، لأنها تتطلّب تحمّل ثقل العلاقة المكسورة بدل إعادة إنتاج العنف (23).
في الإسلام، يظهر الغفران في اقترانه الوثيق بالعدل والإصلاح. فالقرآن لا يفصل بين العفو والإصلاح، ولا يجعل الغفران إلغاءً للمسؤولية، بل تحويلًا لمسارها. فالعفو الذي لا يُصلح يبقى ناقصًا، والإصلاح الذي لا يتضمّن عفوًا يبقى قاصرًا عن ترميم العلاقة. ومن هنا، يُفهم الغفران بوصفه إعادة إدخال الإنسان في أفق التكاؤُن، لا إخراجه من دائرة المساءلة (32)(35).
أما الرهبنة، فتُساء قراءتها حين تُفهم بوصفها قطيعة مع العالم. فالرهبنة، في أصلها الروحي، ليست رفضًا للعالم، بل احتجاجًا على عالم فقد معناه. إنها فعل انقطاع عن منطق الامتلاك والهيمنة، لا عن الإنسان. وقد بيّن ماكس فيبر أن الزهد الديني لا يقوم على الهروب، بل على إعادة تنظيم العلاقة مع العالم على أساس مختلف (18).
في المسيحية، تتجلّى الرهبنة بوصفها محاولة للعيش في أفق الملكوت داخل التاريخ، أي بوصفها شكلًا مكثّفًا من التكاؤُن، حيث تُعاد صياغة العلاقة بين الفرد والجماعة والزمن. فالرهبان لا ينسحبون من الإنسانية، بل يحملون جراحها في صمت، ويحوّلون العزلة إلى فضاء صلاة من أجل العالم، لا ضدّه (23).
ويظهر هذا المعنى أيضًا في التجربة الصوفية الإسلامية، حيث لا يُفهم الزهد بوصفه رفضًا للحياة، بل تحريرًا للقلب من التعلّق الذي يمنع العلاقة الصادقة. فالتصوّف، في جوهره، ليس انقطاعًا عن الناس، بل سعيًا إلى محبّتهم من دون امتلاكهم. وقد أشار ابن عربي إلى أن العارف الحقيقي لا يرى في الآخر سوى تجلٍّ للحق، ما يجعل العلاقة معه فعل عبادة لا مجرّد واجب أخلاقي (35).
من هنا، يلتقي الغفران والرهبنة في كونهما ممارستين تُعيدان فتح أفق المعنى حين يُغلق. فالغفران يُرمّم العلاقة المنكسرة، والرهبنة تحرس إمكان العلاقة من التشيّؤ. وكلاهما يشتغلان ضد منطق السوق والعنف والهيمنة، لا عبر المواجهة المباشرة، بل عبر إعادة تأسيس العلاقة على مستوى أعمق.
يُغلق هذا العنوان الفرعي القسم الثاني بإظهار أن الدين، في أفق التكاؤُن، ليس نظامًا عقائديًا مكتفيًا بذاته، بل حركة مستمرّة لإعادة بناء العلاقة والمعنى داخل التاريخ. فحيث يُستعاد الغفران بوصفه قوة علائقية، وحيث تُفهم الرهبنة بوصفها انخراطًا روحيًا في العالم، يُفتح أفق جديد لإنسانية الإنسان.
بعد أن عالج هذا القسم الدين والدعوات والنبوات بوصفها استجابات تاريخية–روحية لانكسار العلاقة، بات من الممكن الانتقال من مستوى الخطاب الديني بوظيفته الترميمية إلى مستوى أوسع يتعلّق بإنسانية الإنسان ذاتها ومصيره المشترك. فإذا كانت النبوة قد ظهرت حين انهار التكاؤُن، وكانت الشريعة قد سعت إلى حفظه، وكان الخلاص والغفران قد استهدفا ترميمه، فإن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: ما الذي يبقى من الإنسان حين يُستعاد التكاؤُن؟ وما الصورة التي يتّخذها الوجود الإنساني حين تُعاد صياغته على أساس العلاقة لا الهيمنة، وعلى الشركة لا الإقصاء؟
إن ما كشفه هذا القسم هو أن الدين، في جوهره، لا يعمل خارج الإنسان ولا فوقه، بل في عمق بنيته العلائقية. فحين يُفهم الدين بوصفه فعل إعادة تأسيس للمعنى داخل العلاقة، يصبح من الضروري الانتقال إلى تحليل الإنسان نفسه: كيف تتكوّن إنسانيته؟ كيف يُعاد تعريف الفرد والجماعة؟ وكيف يُفهم المصير المشترك في عالم لم يعد يحتمل العزلة أو الانقسام؟
من هنا، يُمهّد هذا الانتقال للدخول في القسم الثالث، الذي لن يعالج الدين بوصفه موضوعًا، بل سيعالج الإنسان بوصفه ثمرة التكاؤُن وفاعله في آن، في أفق أنثروبولوجي–فلسفي–تاريخي جامع.
القسم الثالث
الإنسان، المصير المشترك، والعودة إلى الواحد
التكاؤُن كأفق أنثروبولوجي–تاريخي للوجود الإنساني
تمهيد القسم الثالث
بعد أن بيّن القسمان الأوّل والثاني أن التكاؤُن يشكّل بنية أنطولوجية للوجود ووظيفة روحية–تاريخية للدين، ينتقل هذا القسم إلى المستوى الذي تتقاطع فيه الفلسفة والأنثروبولوجيا والتاريخ: مستوى الإنسان نفسه بوصفه كائنًا تكاؤنيًا. فالإنسان لا يُفهم هنا بوصفه فردًا مستقلًا يُضيف العلاقات إلى وجوده، ولا بوصفه ذائبًا في جماعة تُلغيه، بل بوصفه كينونة تتكوّن داخل شبكة علاقات تجعل الفرد والجماعة والمصير عناصر متلازمة.
يفترض هذا القسم أن أزمة الإنسان المعاصر—من العزلة الوجودية إلى العنف الجماعي—هي نتيجة مباشرة لفهم ناقص للإنسان، يفصل بين الفرد والجماعة، وبين الحرية والمسؤولية، وبين التعدّد والوحدة. ومن هنا، يسعى القسم الثالث إلى إعادة بناء مفهوم إنسانية الإنسان انطلاقًا من التكاؤُن، بوصفه أفقًا يتيح فهم المصير المشترك والعودة إلى الواحد من دون إلغاء التعدّد، ومن دون الوقوع في شمولية قسرية أو فردانية مفرغة من المعنى.
سيُعالج هذا القسم أربعة محاور مترابطة:
الإنسان ككائن تكاؤني بين الفرد والجماعة،
المصير المشترك والذاكرة التاريخية،
الواحد والمتعدّد: نقد الشمولية والتفكّك،
العودة إلى الواحد: الموت، النهاية، والمعنى.
1. الإنسان بين الفرد والجماعة: نقد الفردانية والشمولية من منظور تكاؤني
هيمنت الفردانية على الفكر الحديث بوصفها الإطار الذي يُعرَّف فيه الإنسان كذات مستقلة، مالكة لذاتها، وقادرة على تقرير مصيرها بمعزل عن الآخرين. وقد ارتبط هذا التصوّر بتحرير الإنسان من السلطات التقليدية، غير أنه أسّس في الوقت نفسه لعزلة وجودية عميقة، حيث غدا الآخر منافسًا أو تهديدًا أو أداة، لا شرطًا للتكوُّن (18)(19).
في المقابل، سقطت بعض المقاربات الجماعية في شمولية تُذيب الفرد في الكلّ، وتحوّل الجماعة إلى كيان متعالٍ يبرّر القمع باسم الوحدة أو الهوية أو المصلحة العليا. وقد بيّن تاريخ القرن العشرين أن هذا المنطق يُنتج أشكالًا قصوى من العنف، لأنه ينفي الفرد بوصفه حاملًا للمعنى والمسؤولية (19).
ينطلق مفهوم التكاؤُن من نقد هذين النموذجين معًا. فالإنسان، في أفق التكاؤُن، لا يوجد بوصفه فردًا قبل الجماعة، ولا بوصفه عنصرًا ذائبًا فيها، بل بوصفه كائنًا يتكوّن فردًا بقدر ما يتكوّن مع الآخرين. فالفردانية التي تنكر الجماعة تُفرغ الذات من المعنى، والجماعية التي تنكر الفرد تُفرغ الجماعة من الإنسانية.
يتقاطع هذا الفهم مع التحليل الأنثروبولوجي لإميل دوركهايم، الذي رأى أن الفرد لا يتشكّل إلا داخل مجتمع يمنحه اللغة والرموز والمعايير (5). غير أن التكاؤُن يضيف بعدًا أنطولوجيًا إلى هذا الطرح، إذ لا يكتفي بالقول إن المجتمع يؤثّر في الفرد، بل يؤكّد أن الفرد والجماعة يتكوّنان معًا داخل علاقة تأسيسية واحدة.
كما يتقاطع مع فلسفة بول ريكور، الذي شدّد على أن الهوية الشخصية لا تُفهم إلا بوصفها هوية سردية تتشكّل عبر الاعتراف المتبادل والزمن المشترك (11). فالإنسان لا يملك قصة جاهزة، بل يكتب ذاته داخل قصة جماعية لا تُلغيه بل تمنحه إمكان القول «أنا» من دون إنكار «نحن».
في هذا الإطار، تُعاد قراءة الحرية بوصفها قدرة على الانخراط في علاقة عادلة، لا بوصفها انفصالًا عن الآخرين. فالحرية التي تنفي التكاؤُن تتحوّل إلى عزلة، والعلاقة التي تنفي الحرية تتحوّل إلى قسر. ومن هنا، لا تُفهم المسؤولية بوصفها عبئًا أخلاقيًا، بل بوصفها وجه الحرية التكاؤنية، حيث يكون الإنسان مسؤولًا لأن وجوده متعلّق بوجود غيره (6)(10).
تؤكّد دراسات علم النفس الاجتماعي أن الهوية الفردية تتفكّك حين تُقطع الروابط الاجتماعية الأساسية، وأن الشعور بالانتماء ليس حاجة ثانوية، بل شرط للصحة النفسية والمعنى (14). وهذا ما يفسّر عودة الهويات المغلقة والعنيفة في سياقات التفكّك الاجتماعي، حيث يبحث الإنسان عن بديل قسري للتكاؤُن المفقود.
في أفق التكاؤُن، لا تكون الجماعة إطارًا يحدّ الفرد، بل فضاءً يُمكّنه من التحقّق. كما لا يكون الفرد خطرًا على الجماعة، بل شرط حيويتها وتجددها. فالاختلاف الفردي لا يُهدّد الوحدة، بل يمنعها من التحجّر. وهنا، يُعاد تعريف التضامن لا بوصفه تطابقًا، بل بوصفه قدرة على حمل الاختلاف داخل علاقة مشتركة.
وعليه، فإن إعادة بناء إنسانية الإنسان تقتضي تجاوز الثنائية الزائفة بين الفرد والجماعة، والاعتراف بأن الإنسان لا يكون إنسانًا إلا بقدر ما يكون مع الآخرين، وبقدر ما يجد في الجماعة مجالًا لتحقيق فرديته لا سحقها. وهذا ما يمهّد للعنوان الفرعي الثاني، الذي سينتقل إلى تحليل المصير المشترك والذاكرة التاريخية بوصفهما بعدين أساسيين للتكاؤُن الإنساني عبر الزمن.
القسم الثالث
الإنسان، المصير المشترك، والعودة إلى الواحد
التكاؤُن كأفق أنثروبولوجي–تاريخي للوجود الإنساني
2. المصير المشترك والذاكرة التاريخية: الزمن بوصفه بُعدًا تكاؤنيًا
يُساء فهم الزمن في كثير من المقاربات الفلسفية والاجتماعية حين يُختزل إلى تسلسل كرونولوجي للأحداث، أو إلى إطار محايد تقع داخله الأفعال الإنسانية. ففي هذا التصوّر، يغدو الماضي مخزونًا من الوقائع المنتهية، ويغدو المستقبل مجالًا للتخطيط التقني، بينما يُفرَّغ الحاضر من كثافته الوجودية. غير أن هذا الفهم يعجز عن تفسير كيفية تشكّل المعنى عبر التاريخ، وعجزه الأعمق يظهر في تفسير الأزمات الجماعية التي تعود لتكرار نفسها رغم تغيّر الظروف (4)(11).
ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن الزمن الإنساني ليس مجرّد تعاقب لحظات، بل حقل علائقي تتكوّن فيه الذوات والجماعات عبر ذاكرة مشتركة ومصير متشابك. فالإنسان لا يعيش الزمن وحده، ولا يصنع تاريخه بمعزل عن الآخرين، بل يوجد دائمًا داخل تاريخ مُشترك تتقاطع فيه الحيوات، والآلام، والآمال، والخيبات. ومن هنا، لا يكون المصير المشترك مفهومًا أخلاقيًا مثاليًا، بل حقيقة أنثروبولوجية–تاريخية.
لقد بيّن مارتن هايدغر أن الوجود الإنساني وجود زماني في جوهره، وأن الإنسان لا يفهم ذاته إلا من خلال إسقاطه في المستقبل، وعودته إلى ماضيه، وانخراطه في حاضرٍ مشترك (4). غير أن التحليل الهايدغري، على عمقه، ظلّ متمركزًا حول الوجود الفردي (Dasein)، ولم يُفكّك بما يكفي البعد الجماعي للزمن بوصفه مجالًا لتكوُّن المعنى المشترك.
يُكمّل مفهوم التكاؤُن هذا النقص، عبر التأكيد على أن الزمن لا يُعاش فرديًا فقط، بل يُبنى جماعيًا عبر الذاكرة والاعتراف والسرد. فالذاكرة ليست أرشيفًا للأحداث، بل بنية علائقية تُحدِّد كيفية حضور الماضي في الحاضر، وكيفية فتح المستقبل أو إغلاقه. وقد أظهر بول ريكور أن الذاكرة الجماعية لا تُفهم إلا من خلال السرد، وأن السرد بدوره فعل اعتراف يربط الذوات ببعضها عبر الزمن (11).
في هذا السياق، لا يكون النسيان دائمًا نقيض الذاكرة، بل قد يكون شكلًا من أشكال العنف حين يُفرض قسرًا، أو حين يُستعمل لإنكار الألم الجماعي. وقد بيّنت دراسات العدالة الانتقالية أن المجتمعات التي لا تواجه ماضيها تفشل في بناء مستقبل مستقر، لأن الجراح غير المعالجة تعود بأشكال جديدة من العنف (18)(24). فالزمن، حين يُفهم خارج أفق التكاؤُن، يتحوّل إلى إعادة إنتاج للصدمة بدل أن يكون مجالًا للشفاء.
يُتيح مفهوم المصير المشترك إعادة قراءة العلاقة بين الفرد والتاريخ. فالفرد لا يُختزل إلى ضحية للتاريخ، ولا يُفهم بوصفه صانعه المطلق، بل بوصفه فاعلًا يتكوّن داخل شبكة تاريخية سابقة عليه، ويؤثّر فيها بقدر ما يتأثّر بها. ومن هنا، لا يكون تحمّل المسؤولية التاريخية عبئًا أخلاقيًا مفروضًا، بل نتيجة طبيعية للانتماء إلى مصير مشترك لا يمكن الانفصال عنه.
يتجلّى هذا البعد بوضوح في التجربة الدينية، حيث تُفهم الخطيئة والخلاص، والرجاء واليأس، بوصفها أحداثًا لا تخصّ الفرد وحده، بل الجماعة عبر الزمن. ففي المسيحية، مثلًا، لا يُفهم الخلاص إلا بوصفه تاريخ خلاص، أي مسارًا جماعيًا تتداخل فيه الأجيال (23). وفي الإسلام، يظهر هذا البعد في مفهوم الأمة بوصفها جماعة تاريخية تتحمّل مسؤولية الشهادة على الناس، لا بوصفها هوية مغلقة، بل بوصفها حاملًا لمصير أخلاقي مشترك (32)(35).
كما تُظهر الأنثروبولوجيا الثقافية أن الطقوس، والأساطير، والاحتفالات الجماعية ليست بقايا ماضٍ بدائي، بل آليات رمزية لإعادة ربط الجماعة بزمنها المشترك، وحماية المعنى من التلاشي. وقد بيّن كلود ليفي-شتراوس أن البنى الرمزية تُعيد تنظيم الزمن بحيث يصبح قابلًا للعيش، لا مجرّد تعاقب أعمى للأحداث (17).
في أفق التكاؤُن، يصبح الزمن مجالًا لإمكان المصالحة أو الانقسام. فحين تُدار الذاكرة بوصفها سلاحًا، يتحوّل المصير المشترك إلى لعنة، وحين تُدار بوصفها مسؤولية مشتركة، يتحوّل إلى أفق رجاء. ومن هنا، لا يكون السؤال: «كيف ننسى الماضي؟» بل: كيف نُعيد إدخاله في علاقة تُنتج معنى بدل إعادة إنتاج العنف؟
يُظهر هذا التحليل أن المصير المشترك ليس شعارًا أخلاقيًا، بل بنية زمنية–علائقية تُحدِّد إمكانية العيش معًا. فالإنسان لا يمكنه الهروب من تاريخه، لكنه يستطيع إعادة تأويله داخل علاقة جديدة. وهذا ما يمهّد للعنوان الفرعي الثالث، الذي سينتقل إلى معالجة إشكالية الواحد والمتعدّد، ونقد النزوع إلى الشمولية أو التفكّك في ضوء مفهوم التكاؤُن.
3. الواحد والمتعدّد: التكاؤُن بين خطر الشمولية ومأزق التفكّك
تُعدّ العلاقة بين الواحد والمتعدّد من أقدم الإشكاليات الفلسفية، وقد شكّلت عبر التاريخ محورًا لصراعات فكرية وسياسية ودينية عميقة. فحين يُختزل الواحد إلى مبدأ كليّ مغلق، يتحوّل إلى شمولية تُقصي الاختلاف باسم الوحدة. وحين يُطلق المتعدّد بلا رابط جامع، يتحوّل إلى تفكّك يُفرغ الوجود من المعنى المشترك. وفي الحالتين، يُصاب الإنسان في صميم إنسانيته، لأن المعنى لا يُحتمل في القسر ولا في التبعثر (1)(15).
ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن المأزق لا يكمن في الواحد أو المتعدّد بحدّ ذاتهما، بل في فهم العلاقة بينهما خارج أفق التكاؤُن. فالواحد، حين يُفهم بوصفه جوهرًا متعاليًا يفرض نفسه على المتعدّد، يُنتج أنظمة شمولية—دينية كانت أم سياسية—تُحوّل الاختلاف إلى تهديد وجودي. والمتعدّد، حين يُفهم بوصفه استقلالًا مطلقًا بلا علاقة، يُنتج فردانيات وهويات متناحرة تفقد القدرة على العيش المشترك (19).
لقد بيّنت الفلسفة الحديثة، ولا سيما في نقدها للميتافيزيقا الكلاسيكية، أن اختزال الوجود إلى وحدة صمّاء يُفضي إلى نفي التاريخ والاختلاف. غير أن ردّ الفعل على هذا الاختزال قاد، في كثير من الأحيان، إلى نقيضه: تفكيك كلّ وحدة، واعتبار المعنى مجرّد بناء اعتباطي. وقد أدّى هذا المسار إلى ما وصفه جان-فرانسوا ليوتار بـ«انهيار السرديات الكبرى»، حيث فقد الإنسان أفق المعنى المشترك، من دون أن يكتسب بديلًا علائقيًا قادرًا على جمع التعدّد (20).
يُقدّم مفهوم التكاؤُن بديلًا عن هذين المنهجين. فالواحد، في أفق التكاؤُن، لا يُفهم بوصفه مركزًا قاهرًا، بل بوصفه أفقًا علائقيًا ينبثق من التعدّد ويحفظه في آن. والمتعدّد لا يُفهم بوصفه تشظّيًا، بل بوصفه غنى لا يُحتمل إلا داخل علاقة تحفظ إمكان اللقاء. بهذا المعنى، لا يُلغِي الواحد المتعدّد، ولا يذوب المتعدّد في الواحد، بل يتكوّنان معًا داخل حركة مستمرّة.
يتقاطع هذا التصوّر مع بعض التيارات الفلسفية التي حاولت تجاوز ثنائية الوحدة والتعدّد. فقد رأى سبينوزا أن الوجود يقوم على جوهر واحد تتجلّى صفاته في أنماط متعدّدة، غير أن هذا التصوّر بقي أسيرًا لمبدأ الجوهر الواحد الذي يحدّ من استقلالية العلاقة (1). وفي المقابل، شدّد إيمانويل ليفيناس على لانهائية الآخر ورفض اختزاله في أي كلّية، غير أن هذا التشديد، حين يُفصل عن أفق مشترك، يُخاطر بتحويل العلاقة إلى توتّر دائم بلا أفق جامع (6).
يأتي التكاؤُن ليجمع بين هذين البعدين: حفظ لانهائية الآخر من دون تفكيك الأفق المشترك. فالواحد، هنا، ليس حقيقة جاهزة تُفرض، بل مسارًا يُبنى عبر الاعتراف المتبادل. ومن هنا، تُعاد قراءة مفاهيم مثل الأمة، والكنيسة، والمجتمع، لا بوصفها كتلًا متجانسة، بل بوصفها فضاءات علائقية تتّسع للاختلاف من دون أن تفقد وحدتها.
يتجلّى خطر الشمولية حين يُختزل الواحد في هوية مغلقة—دينية، قومية، أو أيديولوجية—تطالب بالولاء المطلق، وتحوّل الاختلاف إلى خيانة. وقد أظهر تاريخ القرن العشرين كيف قادت هذه الشموليات إلى أنظمة إبادة، لأنها نزعت عن الإنسان فرديته باسم الكلّ (19). وفي المقابل، يتجلّى مأزق التفكّك حين تُرفع التعدّدية إلى مستوى إنكار أي رابط جامع، فيتحوّل المجتمع إلى تجاور هشّ لمصالح وهويات متنافسة، فاقدة لأي مشروع مشترك (20).
في أفق التكاؤُن، يُعاد تعريف الانتماء بوصفه انخراطًا حرًّا في علاقة مشتركة، لا ذوبانًا ولا انفصالًا. فالانتماء الحقيقي لا يطلب من الفرد أن يتخلّى عن اختلافه، بل أن يضعه في خدمة علاقة أوسع. ومن هنا، لا تكون الوحدة نقيض الحرية، بل شرطًا لتحقّقها داخل علاقة تحمي الاختلاف من التحوّل إلى صراع.
كما يُتيح هذا الإطار فهم النزاعات المعاصرة على نحو أعمق. فغالبًا ما تُفسَّر هذه النزاعات بوصفها صراعات مصالح أو هويات، غير أن جذورها الأعمق تكمن في فشل بناء واحد علائقي يتّسع للتعدّد. فحين يغيب هذا الأفق، لا يبقى أمام الجماعات سوى خيارين مدمّرين: الهيمنة أو الانسحاب.
يُظهر هذا التحليل أن الخروج من مأزق الشمولية والتفكّك لا يتمّ عبر حلول تقنية أو قانونية فحسب، بل عبر إعادة تأسيس العلاقة بين الواحد والمتعدّد على أساس تكاؤني. وهذا ما يمهّد للعنوان الفرعي الرابع والأخير من القسم الثالث، الذي سيتناول مسألة العودة إلى الواحد في أفق الموت، والنهاية، والمعنى، بوصفها ذروة التجربة الإنسانية المشتركة.
4. العودة إلى الواحد: الموت، النهاية، والمعنى في أفق التكاؤُن
يشكّل الموت الحدّ الأقصى للتجربة الإنسانية، والنقطة التي تتكثّف عندها أسئلة المعنى والوجود والعلاقة. وقد جرى، في كثير من المقاربات الفلسفية الحديثة، التعامل مع الموت بوصفه حدثًا فرديًا خالصًا، لحظة انقطاع نهائي تُعيد الإنسان إلى عزلته القصوى. غير أن هذا الفهم، على عمقه الوجودي، يبقى ناقصًا إذا لم يُقرأ الموت في أفق العلاقة والمصير المشترك (4)(11).
ينطلق هذا البحث من فرضية مفادها أن الموت لا يكشف فقط هشاشة الفرد، بل يكشف أيضًا حقيقة التكاؤُن التي قامت عليها حياته. فالإنسان لا يموت وحده كما لم يعش وحده؛ إذ إن أثره، وذاكرته، ومعناه، لا ينتهون بانقطاع الجسد، بل يستمرّون داخل شبكة العلاقات التي أسهم في تكوينها. ومن هنا، لا تكون العودة إلى الواحد محوًا للتعدّد، بل اكتمالًا لمسار تكاؤني بدأ في الحياة.
في فلسفة هايدغر، يُفهم الموت بوصفه «إمكان الإمكانات»، أي الحدّ الذي يمنح الحياة جديّتها ويحرّرها من التفاهة (4). غير أن هذا التحليل، حين يُفصل عن البعد العلائقي، يُخاطر بتحويل الموت إلى تجربة انعزالية تُعلي من فردانية القلق. أمّا في أفق التكاؤُن، فيُفهم الموت بوصفه لحظة كشف لمعنى العلاقة: ما الذي يبقى من الإنسان حين ينقطع حضوره الفيزيائي؟ وما الذي يعود إلى الواحد عبر الآخرين؟
يتقاطع هذا الفهم مع اللاهوت المسيحي الذي يرى في الموت عبورًا لا فناءً، وفي القيامة اكتمالًا للشركة لا إلغاءً للتميّز. فالعودة إلى الله لا تُفهم بوصفها ذوبانًا في المطلق، بل دخولًا في شركة تحفظ الشخص داخل وحدة أوسع (communio) (23). وفي هذا الأفق، لا يكون الواحد نقيض التعدّد، بل أفقًا يحتضنه ويمنحه معناه الأخير.
وفي الإسلام، يظهر هذا المعنى في التأكيد على أن الإنسان يعود إلى الله فردًا، لكنه يُحاسَب داخل أفق الجماعة، وأن الأعمال لا تُفهم إلا في علاقتها بالآخرين. فالموت ليس نهاية العلاقة، بل انتقالًا إلى مستوى آخر من المسؤولية والمعنى، حيث تتكشّف حقيقة الاستخلاف بوصفه أمانة علائقية لا تُختزل في الحياة الدنيا (32)(35).
كما تُظهر الأنثروبولوجيا الثقافية أن طقوس الموت ليست مجرّد تعبيرات رمزية عن الحزن، بل آليات جماعية لإعادة إدماج الفقد في المعنى المشترك. فالحداد، والذكرى، والطقوس الجنائزية، كلّها أشكال تكاؤنية تُعيد وصل الميت بالجماعة، وتحمي الأحياء من التفكّك أمام تجربة الفناء (17)(18).
في أفق التكاؤُن، لا تُفهم العودة إلى الواحد بوصفها إلغاءً للفرد، بل بوصفها تحقّقًا نهائيًا لمعناه داخل الكلّ. فالإنسان، الذي تكوّن عبر علاقاته، لا «يذوب» في الواحد، بل يعود إليه محمّلًا بأثر تلك العلاقات. ومن هنا، لا يكون الواحد جوهرًا مجرّدًا، بل ذاكرة حيّة للعلاقات التي صنعت الوجود الإنساني.
يفتح هذا الفهم أفقًا جديدًا لمعنى الرجاء. فالرجاء لا يقوم على إنكار الموت، ولا على وعد تقني بالخلود، بل على الثقة بأن العلاقة التي منحت الحياة معناها لا تُمحى بالانقطاع البيولوجي. وقد شدّد بول ريكور على أن الرجاء الحقيقي يقوم على إعادة سرد الحياة في أفق يتجاوز الموت من دون أن يُلغيه (11).
وعليه، فإن نهاية الإنسان ليست قطيعة مع المعنى، بل لحظة اكتمال لمسار تكاؤني عاشه مع الآخرين، ومن أجل الآخرين، وبالآخرين. فالعودة إلى الواحد لا تُلغِي التعدّد، بل تحفظه في مستوى أعمق، حيث لا يعود الاختلاف سبب صراع، بل علامة غنى.
يُغلق هذا العنوان الفرعي القسم الثالث بإظهار أن التكاؤُن لا يقتصر على الحياة الاجتماعية أو الدينية، بل يمتدّ إلى أقصى حدود الوجود الإنساني: الموت والمعنى. فحيث يُفهم الموت في أفق العلاقة، لا يعود نهاية عبثية، بل خاتمة ذات معنى لمسار إنساني مشترك.
بعد استكمال التحليل الفلسفي والأنطولوجي للتكاؤُن في القسم الأوّل، والكشف عن وظيفته الروحية–التاريخية في الدين والدعوات في القسم الثاني، ثم تتبّع تجلّياته الأنثروبولوجية والتاريخية في إنسانية الإنسان ومصيره المشترك في القسم الثالث، يصبح من الممكن الانتقال من التفكيك والتحليل إلى التركيب والتقويم.
لقد أظهر مسار البحث أن التكاؤُن ليس مفهومًا نظريًا معزولًا، ولا مقاربة جزئية تُضاف إلى حقل معرفي بعينه، بل إطارًا شاملاً يعيد تنظيم فهم الإنسان والعلاقة والمعنى والدين والتاريخ ضمن بنية واحدة متماسكة. فالوجود الإنساني، كما بيّن البحث، لا يقوم على الذات المنعزلة ولا على الكلّ القاهر، بل على علاقة تأسيسية تتكوّن فيها الذات والآخر والعالم في آن واحد.
كما تبيّن أن الأزمات المعاصرة—من تفكّك المعنى، إلى عودة العنف، إلى انكسار الثقة بين الإنسان وأخيه—لا يمكن فهمها أو معالجتها من دون مساءلة البنية العلائقية التي تجعل الوجود الإنساني ممكنًا. فحين ينهار التكاؤُن، تنهار معه الأخلاق والدين والسياسة، لا بوصفها أنظمة مستقلة، بل بوصفها تعبيرات مختلفة عن العلاقة ذاتها.
من هنا، لا تأتي الخاتمة بوصفها تلخيصًا لما سبق، بل بوصفها لحظة تركيب نهائي يُعاد فيها جمع خيوط البحث في أفق واحد، وتُستخلص منها نتائج نظرية، ودلالات إنسانية، وإشارات مفتوحة على المستقبل. فالغاية ليست إغلاق النقاش، بل فتحه على مستوى أعمق، حيث يُعاد التفكير في إنسانية الإنسان لا انطلاقًا من السيطرة أو الامتلاك، الخاتمة العامة
سعى هذا البحث إلى إعادة تأسيس فهم الإنسان والمعنى والدين والتاريخ انطلاقًا من مفهوم التكاؤُن بوصفه بنية أنطولوجية وعلائقية سابقة على كل تشريع، وكل أخلاق، وكل تنظيم اجتماعي أو ديني. وقد بيّن المسار التحليلي، عبر أقسامه الثلاثة، أن الأزمة الإنسانية المعاصرة ليست في نقص القيم أو غياب المعرفة أو فشل المؤسسات فحسب، بل في انهيار البنية العلائقية التي يتكوّن فيها الإنسان أصلًا.
في القسم الأوّل، أظهر البحث أن الانتقال من أنطولوجيا الجوهر إلى أنطولوجيا العلاقة ليس تحوّلًا اصطلاحيًا، بل انقلابًا في فهم الوجود ذاته. فالإنسان لا يوجد كذات مكتفية تدخل في علاقات لاحقة، بل يتكوّن بوصفه ذاتًا من خلال علاقة تأسيسية مع الآخر والعالم. ومن هنا، تبيّن أن المعنى لا يُنتج داخل وعي معزول، بل ينبثق داخل شبكة اعتراف متبادل تحفظ التماثل من دون تطابق، والاختلاف من دون صراع.
وفي القسم الثاني، أعاد البحث قراءة الدين والدعوات والنبوات بوصفها استجابات تاريخية–روحية لانكسار التكاؤُن، لا بوصفها أنظمة مفصولة عن التجربة الإنسانية. فالنبوة ظهرت حيث اختلّ التوازن العلائقي، والشريعة وُجدت لحماية شروط العلاقة، والخطيئة عبّرت عن انكسارها، والخلاص سعى إلى ترميمها، فيما مثّل الغفران والرهبنة شكلين مختلفين من مقاومة انهيار المعنى داخل التاريخ. وبهذا، تبيّن أن الدين، في جوهره، ليس خطاب سلطة ولا منظومة ضبط، بل فعل إعادة إنسانية الإنسان.
أما القسم الثالث، فقد نقل التحليل إلى مستوى الإنسان والمصير المشترك، مبيّنًا أن الفرد والجماعة، والواحد والمتعدّد، والحياة والموت، لا تُفهم إلا داخل أفق تكاؤني يحفظ العلاقة من التحجّر والتفكّك معًا. فالإنسان لا يحقّق فرديته إلا داخل الجماعة، ولا تستقيم الجماعة إلا بحفظ الفرد؛ والمصير المشترك ليس شعارًا أخلاقيًا، بل حقيقة تاريخية–زمنية؛ والعودة إلى الواحد ليست ذوبانًا في المطلق، بل اكتمالًا لمسار علائقي عاشه الإنسان مع الآخرين.
وعليه، يخلص البحث إلى أن التكاؤُن يشكّل إطارًا تفسيريًا وتأسيسيًا جامعًا، قادرًا على ربط الفلسفة بالدين، والأنثروبولوجيا بالأخلاق، والوجود بالمعنى، من دون اختزال أي حقل في الآخر. كما يفتح هذا الإطار أفقًا جديدًا لفهم الأزمات المعاصرة بوصفها أزمات علاقة قبل أن تكون أزمات نظام، ويقترح أن أي مشروع نهضوي—إنساني، ديني، أو معرفي—لا يمكن أن ينجح ما لم يُعاد بناؤه على أساس تكاؤني يحفظ إنسانية الإنسان في عالم يتآكل فيه المعنى.
التوصيات العلمية والمنهجية
انطلاقًا من نتائج البحث، يمكن صياغة التوصيات الآتية على نحو علمي مترابط:
أولًا: توصيات نظرية–فلسفية
اعتماد مفهوم التكاؤُن إطارًا أنطولوجيًا في الدراسات الفلسفية المعاصرة، بدل الاقتصار على نماذج الذات المستقلة أو البنى الشمولية، لما يتيحه من تجاوز ثنائيات الجوهر/العلاقة، والفرد/الجماعة.
إعادة قراءة مفاهيم الهوية، والحرية، والمسؤولية، والمعنى، في ضوء البنية العلائقية للوجود، بما يسمح بتطوير فلسفة إنسانية غير إقصائية وغير اختزالية.
تشجيع الأبحاث العابرة للتخصصات التي تدمج الفلسفة بالأنثروبولوجيا وعلم النفس الاجتماعي، ضمن أفق تكاؤني لا هرمي.
ثانيًا: توصيات لاهوتية ودينية
إعادة تأويل الخطاب الديني بوصفه خطاب ترميم علاقة لا خطاب ضبط أو هيمنة، بما يحدّ من النزعات العنفية والإقصائية.
إدماج البعد التكاؤني في الدراسات اللاهوتية المقارنة، خصوصًا في مفاهيم النبوة، والشريعة، والخلاص، والغفران.
تطوير مقاربات دينية تُبرز أن العلاقة بالآخر شرط العلاقة بالله، لا نتيجة ثانوية لها.
ثالثًا: توصيات تربوية ومعرفية
إدخال مفهوم التكاؤُن في المناهج التربوية والفكرية، بوصفه أساسًا لفهم الإنسان والمجتمع، لا كمفهوم أخلاقي تجميلي.
إعادة بناء التعليم الإنساني على أساس العلاقة والمعنى المشترك، لا على التنافس الفردي الصرف أو الامتثال الشكلي.
تشجيع التفكير النقدي الذي يربط المعرفة بالمسؤولية العلائقية، لا بالاكتفاء التقني.
رابعًا: توصيات اجتماعية–إنسانية
اعتماد مقاربة تكاؤنية في معالجة النزاعات المجتمعية، تقوم على ترميم العلاقة والذاكرة المشتركة بدل الاكتفاء بالحلول الإجرائية.
دعم سياسات ثقافية وإنسانية تعترف بالمصير المشترك وتقاوم منطق التفكّك أو الشمولية.
تعزيز ممارسات الغفران والعدالة التصالحية بوصفها أدوات علائقية لإعادة بناء المعنى داخل المجتمعات المنكسرة.
بل من التكاؤُن بوصفه شرط الوجود والمعنى.
المراجع:
1- أرسطو، الميتافيزيقا، ترجمة إسحاق بن حنين، تحقيق عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، د.ت.
2- رينيه ديكارت، تأملات ميتافيزيقية، ترجمة جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1980.
3- Gerhard von Rad، Old Testament Theology، المجلد الأول، Harper & Row، نيويورك، 1962.
4- Martin Heidegger، Being and Time، ترجمة John Macquarrie & Edward Robinson، Harper & Row، نيويورك، 1962.
5- Émile Durkheim، The Division of Labor in Society، ترجمة W.D. Halls، Free Press، نيويورك، 1984.
6- Emmanuel Levinas، Totality and Infinity، ترجمة Alphonso Lingis، Duquesne University Press، بيتسبرغ، 1969.
7- Hans-Georg Gadamer، Truth and Method، ترجمة Joel Weinsheimer & Donald G. Marshall، Continuum، نيويورك، 2004.
8- Martin Buber، I and Thou، ترجمة Walter Kaufmann، Scribner، نيويورك، 1970.
9- Charles Taylor، Sources of the Self، Harvard University Press، كامبريدج، 1989.
10- Paul Ricoeur، Oneself as Another، ترجمة Kathleen Blamey، University of Chicago Press، شيكاغو، 1992.
11- Paul Ricoeur، Memory, History, Forgetting، ترجمة Kathleen Blamey & David Pellauer، University of Chicago Press، شيكاغو، 2004.
12- Hannah Arendt، The Human Condition، University of Chicago Press، شيكاغو، 1958.
13- Jürgen Habermas، The Theory of Communicative Action، المجلد الأول، Beacon Press، بوسطن، 1984.
14- Erik H. Erikson، Identity: Youth and Crisis، W.W. Norton، نيويورك، 1968.
15- G.W.F. Hegel، Phenomenology of Spirit، ترجمة A.V. Miller، Oxford University Press، أكسفورد، 1977.
16- Gabriel Marcel، Being and Having، ترجمة Katharine Farrer، Westminster Press، لندن، 1949.
17- Claude Lévi-Strauss، Structural Anthropology، Basic Books، نيويورك، 1963.
18- Max Weber، The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism، ترجمة Talcott Parsons، Scribner، نيويورك، 1958.
19- Michel Foucault، Discipline and Punish، ترجمة Alan Sheridan، Pantheon Books، نيويورك، 1977.
20- Jean-François Lyotard، The Postmodern Condition، University of Minnesota Press، مينيابوليس، 1984.
21- Paul Tillich، The Courage to Be، Yale University Press، نيو هافن، 1952.
22- Abraham Joshua Heschel، God in Search of Man، Farrar, Straus and Giroux، نيويورك، 1955.
23- Dietrich Bonhoeffer، The Cost of Discipleship، SCM Press، لندن، 1959.
24- René Girard، Violence and the Sacred، Johns Hopkins University Press، بالتيمور، 1977.
25- Charles Taylor، A Secular Age، Harvard University Press، كامبريدج، 2007.
26- Jan Assmann، Cultural Memory and Early Civilization، Cambridge University Press، كامبريدج، 2011.
27- Paul Ricoeur، The Symbolism of Evil، Beacon Press، بوسطن، 1967.
28- Hans Küng، Christianity: Essence, History, and Future، Continuum، نيويورك، 1995.
29- Karl Rahner، Foundations of Christian Faith، Seabury Press، نيويورك، 1978.
30- محيي الدين ابن عربي، الفتوحات المكية، تحقيق عثمان يحيى، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1985.
31- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
32- القرآن الكريم.
33- إبراهيم بن موسى الشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
34- Seyyed Hossein Nasr، Man and Nature، Harper & Row، نيويورك، 1968.
35- Seyyed Hossein Nasr، Knowledge and the Sacred، SUNY Press، نيويورك، 1989.
36- Nāgārjuna، The Fundamental Wisdom of the Middle Way، Oxford University Press، أكسفورد، 1995.
لا توجد تعليقات بعد.
آخر الأخبار

بحث في أنطولوجيا العلاقة، والدين، وإنسانية الإنسان
بروفسور فريد جبور: رئيس مجلس أمناء جمعية التكاؤن
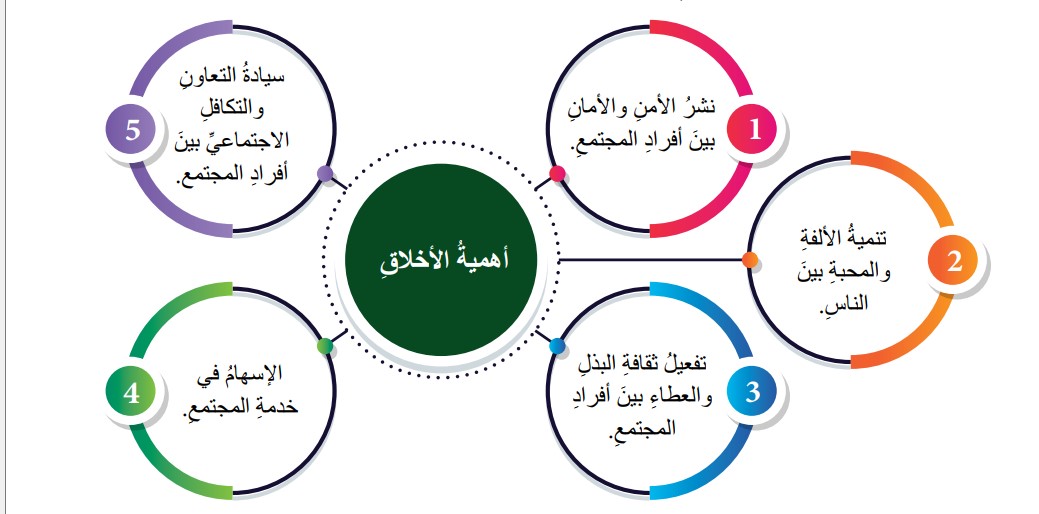
في العلاقة بين الأخلاق والمعارف المستجدّة
البروفسور جهاد نعمان

ماهية الحرية
البروفسور جهاد نعمان

لن توأد لغتنا وأدبنا الحيّ
البروفسور جهاد نعمان

ابحث عن الحكمة
البروفسور جهاد نعمان

بين الارض والسماء(٢)
البروفسور جهاد نعمان

بين الارض والسماء (١)
البروفسور جهاد نعمان

لماذا الثقافة الاميركية؟
البروفسور جهاد نعمان

الأدب بين المبنى والمعنى!
البروفسور جهاد نعمان
Copyrights © 2025 All Rights Reserved. | Powered by OSITCOM